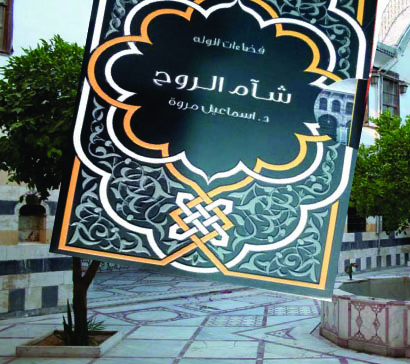
الثوب الدائر يروي سيرة العطر
ثقافة
الاثنين، ٢٥ أبريل ٢٠١٦
نجاح إبراهيم
مقدمة صغيرة لجلال المعشوقة:
قد تكون هناك بداية لحكاية تُروى؟
ولكن عطرها حين تسرَد الأحداثُ المشوقة، لا يقف عند نهاية.
وما العطر سوى العشق، وما السّارد سوى عابد، ينبثقُ من خيوط سجادته ألف سؤال، وكلّ سؤال يأخذ عُمراً، حيث يرمز إلى أنّ حياته في ضفاف معشوقته " الشآااام" لا يحدّها عمر. فمن يحيا بالشام يمتدّ عمره إلى ما لا نهاية، وثمّة عشاق لا ينتهون، ولا يصلون إلى حدّ الارتواء. وثمّة عطر يُغوي الرّيح، حدّ التواطؤ، لترسله إلى جهات لا أفق لها.
رقصُ العابد:
من أين أروي الحكاية؟ حكاية عشق لا توصف؟
أمن خلف نوافذ الشام، حيث يكون العابد، متأملاً، أم من أحد أبوابها، حيث أكونني؟ وهل كنتُ يوماً عابرة؟!
أم أترك العابد، العاشق، يرويها رقصاً؟
أظنني أميل إلى الخيار الثاني، لأدع صاحب الوجد الفريد، يسرد روايته.
إذاً.....
ثمّة حكاية ستروى رقصاً.
يؤديها مولوي، أرّث عشقه بنقاء الرّداء والقلب، والكفين المفتوحتين على مدى.
فكيف سيرويها؟
وهل يستطيع الرّقص؟! أم يقصر عن فصول السرد اللا تنتهي؟
وهل لأطراف الثوب الرّائحة في الاتجاهات الأربعة، أن تلهج بالحكاية، لأرض لا تشبه الحكايات؟!
تعال ندر حول المدى الأبيض الرّامح، نتبع الألق الصوفيّ والوجد، وروائح البخور الطالعة من الجوامع، والكنائس، وأضرحة الأولياء، وأحجار الطرق الغامقة، فيدور العابد أمامنا، وتدور الشآاام بالعابد.
وأدور وإياك خلفهما.
يا للجرار أين هي، لتحوي ما ينثرانه من عبق يتقاطر كما الندى؟!
يدعونا دكتور إسماعيل مروة [1]، في كتابه " شآم الروح- مولوية العشق" [2] لأن نمشي في حارات الشام، التي ستمنحنا الامتلاء بعد الفراغ، الملاذ بعد التعب، والوشم الذي لا يُمحى على جسد الرّغبة، ستكون عنوان الكبرياء للضائع.
فهل درتَ مثلي في أزقتها؟ إنْ فعلت، فارقب ضوء قناديلها، واسهرْ على الأرصفة، ارقبْ النافذة المفتوحة على اللون، المشرعة على الطهر، والمقفلة على سرّ البقاء.
هذه نوافذها يفتحها لك العابد، نافذة تلو الأخرى، فهيا اتبع أطراف ثوبه، أم تراك ستتبع حبره؟
كلاهما مقدسٌ ونقيٌّ.
أيّ طريق تتبع، ستكونه، ذلك المسوّر بالدّهشة، الذي وهبته الشام النشوة، ينقلها إليك المنتشي بالعشق، لتكون مثله، عاشقاً ذا صبوة ممنوحة، القابض بأهدابه على عصارة الشهد وسلافته.
سيحرّرك من كلّ قيد، من خلال ملحمة عشقه للشام، بل يؤكد لك ،أنّ كلّ آلهة الجمال والعشق قد صيغت على أرض الشام. ثم يأخذ بيدك ليلج بك الشوارع، فتدلف في شارع مستقيم فيها، لتجد كنيسة، جامعاً، كاتدرائية، تقرأ بعينيك عراقة هنا، يسبّح لها الكون، وثمّة أيقونة تفوح بالشموخ.
وبرشاقة خطواته، وأناقة رقصه، ينقلك الكاتب مروة، إلى الشارع الذي خرج منه بولص، النور، الذي دخل من الطريق المستقيم، ومنه خرج الحق"ص44
ومن مدخل الجابية، يريك كيف دخل أبو عبيدة بن الجراح بلواء الإسلام، ليطرح في الشارع رسالة للعالمين، رسالة حبّ وإيمان وتضحية وفداء:
" وللعالم كله، أهدت الشام كتاباً وشريعة
إنجيلاً وقرآناً." ص36
وقد يسحبك من يدك، ويأخذك إلى المغاور المحيطة والوديان، والتلال المجاورة، لتتساءل بغبطة: من مرّ من هنا فتعطر المكان؟!
هي الرّائحة علقت بثوب الدّائر، وراحت تروي سيرة العطر القدسي، العشق الذي يتوالد من ذاته، ليصوغ اسم الشآم في قلب هذا الدمشقي المترف بالعشق حتى نهايات أصابعه، ثمّ يعيدك خطفاً إلى سيرة الابن، الذي أنجبته الشام، إلى سيرته الأولى، ليتماهى في كلّ من يرى الشام أمه:
" الكلّ يرى الشام شامته، وشام الرّوح تسعد، تضع رأس هذا في حجرها، تمسح رأس هذا، تشير شام بإصبعها، هنا حنانيا ولدي، وهناك السيدة، ذا عيد التجلي، وذاك ليسوع المولد، وهنا أبو الدرداء، الذي استقر بالشام، وطاب له المقام، لقد وجد الأمان بعد أن ضيعته الغربة، وها هو ابن عربي يلوذ بها بعد أن ضاقت الدنيا به، لم يسعه شرق ولا غرب، وكذا الفارابي المبدع الموسيقي، الذي كانت أوتاره طوق عشق، والشام أعطته سفحها، وأعطته مخدة من تراب، وعطراً من عرفان وحرية."ص40
تلكم السيرة..
يُحيل العاشق شآمه، إلى بوح لا يبتغي سواه.
فيستمر الدائر بثوبه في كشف أسماء من مرّ بها، ودخلها من أبوابها، فيطيل الوقوف عند بابها " الصغير" الذي يعد أوسع من مدن، والذي عبره الكثيرون، أمثال " يوسف العظمة، ورائحة عنفوانه تروي انكسار "غورو"، وثمّة منبر يعتليه فارس الخوري، والشاعر عمر أبي ريشة، وأبو خليل القباني، والبدوي، والبزم، والزركلي و...
ومن شدّة ولعه بالشام، نجده يجيّر – وهو على لهفة وعشق وحق- الأسطورة لأجلها، بل إنّ يد القدر ما نسجت غير شامه، حتى قال فيها:" هي إله ولكن..." ص98
فلأجلها سرق " بروميثيوس" النار المقدّسة، من أجل الأولمب، وقدّمها للإنسان، ولأجلها كانت المرأة " نيدوزا" فتحاً لطريق الخطيئة، لتبقى ربة البراءة " استرايا" شامة الطهر. و" بيرسفوني" التي غابت في الأرض وحزنت أمها " ديمتر" ولكن:
" حزنها أحاط بشام، فكانت شام الحبّ والألق والجمال." ص 111
بينما كان الصراع بين الآلهة لأجل احتضان الشام، والفوز بضفاف شفتيها وشاماتها."
في المتن:
يحار القارئ حين يكون في حضرة المولوي، وهو يدور بعشقه ،عابراً الأكوان بوجده، فيقف مذهولاً أمام ما سُرد.
ليس بإمكانه إلا أنْ ينتشي ،يثمل، لأنّ الكاتب /العاشق استخدم لغة موحية، شعرية، مختزلة. في عمقها بدت رسالتها، وهذه هي لغة التصوف، وكيف لا تكون كذلك وقد تماهى في مولوي، عابد، تقرّب كثيراً من الذات، حتى منحته الكشف، ورفع الحجاب، ومكنته من لغة عصية على السّاردين.
إنّ المفردات التي استخدمها، تجنح بكلّ قوة لتكوّن خطابه الصوفي، وذلك ليرتقي ويتعالى من عالم الحسّ، إلى عالم المعنى، الأسمى، والسير به الى عوالم الإيحاء والإشارة، وفتح ألف باب للتأويل.
رغبة الكاتب في تراتيله هذه، أن تحرّر فكرته من ربقة القيد والعرف، فكان له أن خرقهما بلغته، التي تشكلت نصّاً مغايراً، فخرج عن المألوف، وذلك في طريقة إيصال الفكرة بشكلها التعبيري، المختلف، المتأرجح بين شعر ونثر.
لقد خرج الكاتب عمّا اعتدناه في المزاوجة بين الجنسين، ومنحنا شيئاً جديداً،
فلا يعرف الناهل، إنْ كان يغرف من نبع عبقر أم من سرد؟!
كلاهما مترف بالرّموز والإشارات، وكذا التوتر الذي يتنابض في اللغة، يحيلها بشكل أو بآخر إلى رافض للسائد، ويخلق منها حاضناً للتفرد والجمال.
وما الجمال الذي يباغتنا في كلّ عبارة من عبارات " مولوية العشق" إلا تلك اللغة وشعريتها واختزالها، وما التفرد " إلا خرقاً للقواعد حيناً، ولجوء إلى ما ندر من الصيغ أحياناً."[3]
فأيّ لغة تليق بالآلهة، أو القداسة؟
وكيف تصبّ الفكرة ليصل طهرها للقارئ؟
وبعد..
ثمّة عنوان استوقفني في " مولوية العشق" هو " شآم باب للعابرين، ونوافذ للعابد."
سأترك الشطر الأول منه لأمضي إلى الثاني، لينفتح سؤال:
من العابد، وكيف هي نوافذه؟
إنه صنو الوطن، أو الوجه الآخر لعملة تحمل صورتيهما ،فـ "لا قيمة للوطن من دون العابد الذي يرهن عمره له، يلتقي بالكثيرين، يدخلون ويخرجون، ويبقى الوطن آلة موسيقية تئن إلى أن يتلقاها عازف ماهر للغاية، يصنع اللحون عليها.
" قد يعيش الوطن عشرة آلاف سنة، أو أكثر بانتظار أن يظهر ذلك العاشق، المدنف، والعابد، النابت من تراب الأرض ليقدّم روحه قرباناً لوطنه." ص94
فهذا العابد الذي يجري في عروقه عشق وطن، مختزلاً في الشام، إنما رهنَ الروح والحبر ليعزف بهما أجمل سيمفونية عشق، ممهورة على طرف ثوب مولوي، كلما دار ينثر اللحون، حتى إذا ما اقترب من الذات، منحته الكشف ومتوالية الأسرار. والحقيقة أن المولوي لا يقف عند كشف سرّ، وإنما في دورانه تتوالى الأسرار:
" من سرّ إلى سرّ، وبين كلّ سرّ وسرّ أتكوم بحثاً عن لحظة عشق." ص83
فأيّ عابد هذا؟
وأيّ وطن احتضنه؟
بل أيّ شآم هي، والتي لا تستطيع أن تتوه عنه، وإن فعلت قسراً، فقادرة أن تعتذر له :" لتضمّه من جديد، شلالاً من الحبّ، شلالاً من الغناء، وما بينهما يستمدّ حياة سرمدية."ص106
لهذا انبرى، وبشغف الدوران، أن يروي حكايات المبدعين والصوفيين، ويسرد قصص الأماكن كمغارة الدم في قاسيون، والجندي المجهول، الذي كان بالأمس معلوماً، فغدا مجهولاً اليوم، ومقام النبي يحيى أو الحسين، وسذاب الجوامع، وحمام المآذن، ونمنمات أيقونات الكنائس.
باب العابرين:
وإذا عدنا إلى الشطر الأول من العنوان اللافت، وهو الشآم باب العابرين، فعنده سأقف، وأستذكر كيف كانت بوابة لهؤلاء الذين تمخض عبورهم عن مقولة:
" من عرف دمشق، فقد عرف الشرق كله."[4] ففي القرن الثامن عشر مر بها الرحالة الفرنسي " الكونت دي فولناي" فكتب عنها ما جعل نابليون يندفع إليها غازياً.
كما زارها الشاعر " لامارتين" عام 1833 ليقف أمامها مسحوراً، قال:" تخترق المدينة أنهر سبعة، وجداول لا يحصيها عدد، يمتد على مدى النظر بين البساتين، والرياض المملوء بالزهور، لترسل أذرعها هنا وهناك..."[5]
إنّ دمشق، مدينة خطتها يد العناية على الأرض، وعاصمة خلقها القدر.."[6]
أما العابر الآخر فهو " الكاتب" دي فوكوي" مرّ بها عام 1875، وحين وقف على جبل قاسيون، راح يلملم السحر، ليضعه في روحه المندهشة فقال:" بقعة كبيرة من الحليب في فضاء أخضر فسيح، تحوطها أشجار المشمش والحور..."
أما العابرون بخيالهم، فهم كثر، فالشاعرة الفرنسية الأميرة " آنا دي نوايا " التي سمعت وقرأت عن دمشق، وعن روحانياتها، فقالت:" هل كتب عليّ ألا أشهد أبداً دمشق الخالدة؟ ولكن حين أغمض عيني، تنساب صورة دمشق إلى أعماق نفسي."
كثر هم العابرون، الذين فتحت لهم الشآم باباً.
فهل أنت عابد كإسماعيل مروة، أم عابر؟
إن كنت الأول فانسج ثوبك من بتلات ياسمينها، ودرْ بعشقك في حواريها، ودعنا نلاحق أطرافه الدائر.
وإن كنت الثاني، فاكتم شهقتك، وأرثها عبر حبرك.
مقدمة صغيرة لجلال المعشوقة:
قد تكون هناك بداية لحكاية تُروى؟
ولكن عطرها حين تسرَد الأحداثُ المشوقة، لا يقف عند نهاية.
وما العطر سوى العشق، وما السّارد سوى عابد، ينبثقُ من خيوط سجادته ألف سؤال، وكلّ سؤال يأخذ عُمراً، حيث يرمز إلى أنّ حياته في ضفاف معشوقته " الشآااام" لا يحدّها عمر. فمن يحيا بالشام يمتدّ عمره إلى ما لا نهاية، وثمّة عشاق لا ينتهون، ولا يصلون إلى حدّ الارتواء. وثمّة عطر يُغوي الرّيح، حدّ التواطؤ، لترسله إلى جهات لا أفق لها.
رقصُ العابد:
من أين أروي الحكاية؟ حكاية عشق لا توصف؟
أمن خلف نوافذ الشام، حيث يكون العابد، متأملاً، أم من أحد أبوابها، حيث أكونني؟ وهل كنتُ يوماً عابرة؟!
أم أترك العابد، العاشق، يرويها رقصاً؟
أظنني أميل إلى الخيار الثاني، لأدع صاحب الوجد الفريد، يسرد روايته.
إذاً.....
ثمّة حكاية ستروى رقصاً.
يؤديها مولوي، أرّث عشقه بنقاء الرّداء والقلب، والكفين المفتوحتين على مدى.
فكيف سيرويها؟
وهل يستطيع الرّقص؟! أم يقصر عن فصول السرد اللا تنتهي؟
وهل لأطراف الثوب الرّائحة في الاتجاهات الأربعة، أن تلهج بالحكاية، لأرض لا تشبه الحكايات؟!
تعال ندر حول المدى الأبيض الرّامح، نتبع الألق الصوفيّ والوجد، وروائح البخور الطالعة من الجوامع، والكنائس، وأضرحة الأولياء، وأحجار الطرق الغامقة، فيدور العابد أمامنا، وتدور الشآاام بالعابد.
وأدور وإياك خلفهما.
يا للجرار أين هي، لتحوي ما ينثرانه من عبق يتقاطر كما الندى؟!
يدعونا دكتور إسماعيل مروة [1]، في كتابه " شآم الروح- مولوية العشق" [2] لأن نمشي في حارات الشام، التي ستمنحنا الامتلاء بعد الفراغ، الملاذ بعد التعب، والوشم الذي لا يُمحى على جسد الرّغبة، ستكون عنوان الكبرياء للضائع.
فهل درتَ مثلي في أزقتها؟ إنْ فعلت، فارقب ضوء قناديلها، واسهرْ على الأرصفة، ارقبْ النافذة المفتوحة على اللون، المشرعة على الطهر، والمقفلة على سرّ البقاء.
هذه نوافذها يفتحها لك العابد، نافذة تلو الأخرى، فهيا اتبع أطراف ثوبه، أم تراك ستتبع حبره؟
كلاهما مقدسٌ ونقيٌّ.
أيّ طريق تتبع، ستكونه، ذلك المسوّر بالدّهشة، الذي وهبته الشام النشوة، ينقلها إليك المنتشي بالعشق، لتكون مثله، عاشقاً ذا صبوة ممنوحة، القابض بأهدابه على عصارة الشهد وسلافته.
سيحرّرك من كلّ قيد، من خلال ملحمة عشقه للشام، بل يؤكد لك ،أنّ كلّ آلهة الجمال والعشق قد صيغت على أرض الشام. ثم يأخذ بيدك ليلج بك الشوارع، فتدلف في شارع مستقيم فيها، لتجد كنيسة، جامعاً، كاتدرائية، تقرأ بعينيك عراقة هنا، يسبّح لها الكون، وثمّة أيقونة تفوح بالشموخ.
وبرشاقة خطواته، وأناقة رقصه، ينقلك الكاتب مروة، إلى الشارع الذي خرج منه بولص، النور، الذي دخل من الطريق المستقيم، ومنه خرج الحق"ص44
ومن مدخل الجابية، يريك كيف دخل أبو عبيدة بن الجراح بلواء الإسلام، ليطرح في الشارع رسالة للعالمين، رسالة حبّ وإيمان وتضحية وفداء:
" وللعالم كله، أهدت الشام كتاباً وشريعة
إنجيلاً وقرآناً." ص36
وقد يسحبك من يدك، ويأخذك إلى المغاور المحيطة والوديان، والتلال المجاورة، لتتساءل بغبطة: من مرّ من هنا فتعطر المكان؟!
هي الرّائحة علقت بثوب الدّائر، وراحت تروي سيرة العطر القدسي، العشق الذي يتوالد من ذاته، ليصوغ اسم الشآم في قلب هذا الدمشقي المترف بالعشق حتى نهايات أصابعه، ثمّ يعيدك خطفاً إلى سيرة الابن، الذي أنجبته الشام، إلى سيرته الأولى، ليتماهى في كلّ من يرى الشام أمه:
" الكلّ يرى الشام شامته، وشام الرّوح تسعد، تضع رأس هذا في حجرها، تمسح رأس هذا، تشير شام بإصبعها، هنا حنانيا ولدي، وهناك السيدة، ذا عيد التجلي، وذاك ليسوع المولد، وهنا أبو الدرداء، الذي استقر بالشام، وطاب له المقام، لقد وجد الأمان بعد أن ضيعته الغربة، وها هو ابن عربي يلوذ بها بعد أن ضاقت الدنيا به، لم يسعه شرق ولا غرب، وكذا الفارابي المبدع الموسيقي، الذي كانت أوتاره طوق عشق، والشام أعطته سفحها، وأعطته مخدة من تراب، وعطراً من عرفان وحرية."ص40
تلكم السيرة..
يُحيل العاشق شآمه، إلى بوح لا يبتغي سواه.
فيستمر الدائر بثوبه في كشف أسماء من مرّ بها، ودخلها من أبوابها، فيطيل الوقوف عند بابها " الصغير" الذي يعد أوسع من مدن، والذي عبره الكثيرون، أمثال " يوسف العظمة، ورائحة عنفوانه تروي انكسار "غورو"، وثمّة منبر يعتليه فارس الخوري، والشاعر عمر أبي ريشة، وأبو خليل القباني، والبدوي، والبزم، والزركلي و...
ومن شدّة ولعه بالشام، نجده يجيّر – وهو على لهفة وعشق وحق- الأسطورة لأجلها، بل إنّ يد القدر ما نسجت غير شامه، حتى قال فيها:" هي إله ولكن..." ص98
فلأجلها سرق " بروميثيوس" النار المقدّسة، من أجل الأولمب، وقدّمها للإنسان، ولأجلها كانت المرأة " نيدوزا" فتحاً لطريق الخطيئة، لتبقى ربة البراءة " استرايا" شامة الطهر. و" بيرسفوني" التي غابت في الأرض وحزنت أمها " ديمتر" ولكن:
" حزنها أحاط بشام، فكانت شام الحبّ والألق والجمال." ص 111
بينما كان الصراع بين الآلهة لأجل احتضان الشام، والفوز بضفاف شفتيها وشاماتها."
في المتن:
يحار القارئ حين يكون في حضرة المولوي، وهو يدور بعشقه ،عابراً الأكوان بوجده، فيقف مذهولاً أمام ما سُرد.
ليس بإمكانه إلا أنْ ينتشي ،يثمل، لأنّ الكاتب /العاشق استخدم لغة موحية، شعرية، مختزلة. في عمقها بدت رسالتها، وهذه هي لغة التصوف، وكيف لا تكون كذلك وقد تماهى في مولوي، عابد، تقرّب كثيراً من الذات، حتى منحته الكشف، ورفع الحجاب، ومكنته من لغة عصية على السّاردين.
إنّ المفردات التي استخدمها، تجنح بكلّ قوة لتكوّن خطابه الصوفي، وذلك ليرتقي ويتعالى من عالم الحسّ، إلى عالم المعنى، الأسمى، والسير به الى عوالم الإيحاء والإشارة، وفتح ألف باب للتأويل.
رغبة الكاتب في تراتيله هذه، أن تحرّر فكرته من ربقة القيد والعرف، فكان له أن خرقهما بلغته، التي تشكلت نصّاً مغايراً، فخرج عن المألوف، وذلك في طريقة إيصال الفكرة بشكلها التعبيري، المختلف، المتأرجح بين شعر ونثر.
لقد خرج الكاتب عمّا اعتدناه في المزاوجة بين الجنسين، ومنحنا شيئاً جديداً،
فلا يعرف الناهل، إنْ كان يغرف من نبع عبقر أم من سرد؟!
كلاهما مترف بالرّموز والإشارات، وكذا التوتر الذي يتنابض في اللغة، يحيلها بشكل أو بآخر إلى رافض للسائد، ويخلق منها حاضناً للتفرد والجمال.
وما الجمال الذي يباغتنا في كلّ عبارة من عبارات " مولوية العشق" إلا تلك اللغة وشعريتها واختزالها، وما التفرد " إلا خرقاً للقواعد حيناً، ولجوء إلى ما ندر من الصيغ أحياناً."[3]
فأيّ لغة تليق بالآلهة، أو القداسة؟
وكيف تصبّ الفكرة ليصل طهرها للقارئ؟
وبعد..
ثمّة عنوان استوقفني في " مولوية العشق" هو " شآم باب للعابرين، ونوافذ للعابد."
سأترك الشطر الأول منه لأمضي إلى الثاني، لينفتح سؤال:
من العابد، وكيف هي نوافذه؟
إنه صنو الوطن، أو الوجه الآخر لعملة تحمل صورتيهما ،فـ "لا قيمة للوطن من دون العابد الذي يرهن عمره له، يلتقي بالكثيرين، يدخلون ويخرجون، ويبقى الوطن آلة موسيقية تئن إلى أن يتلقاها عازف ماهر للغاية، يصنع اللحون عليها.
" قد يعيش الوطن عشرة آلاف سنة، أو أكثر بانتظار أن يظهر ذلك العاشق، المدنف، والعابد، النابت من تراب الأرض ليقدّم روحه قرباناً لوطنه." ص94
فهذا العابد الذي يجري في عروقه عشق وطن، مختزلاً في الشام، إنما رهنَ الروح والحبر ليعزف بهما أجمل سيمفونية عشق، ممهورة على طرف ثوب مولوي، كلما دار ينثر اللحون، حتى إذا ما اقترب من الذات، منحته الكشف ومتوالية الأسرار. والحقيقة أن المولوي لا يقف عند كشف سرّ، وإنما في دورانه تتوالى الأسرار:
" من سرّ إلى سرّ، وبين كلّ سرّ وسرّ أتكوم بحثاً عن لحظة عشق." ص83
فأيّ عابد هذا؟
وأيّ وطن احتضنه؟
بل أيّ شآم هي، والتي لا تستطيع أن تتوه عنه، وإن فعلت قسراً، فقادرة أن تعتذر له :" لتضمّه من جديد، شلالاً من الحبّ، شلالاً من الغناء، وما بينهما يستمدّ حياة سرمدية."ص106
لهذا انبرى، وبشغف الدوران، أن يروي حكايات المبدعين والصوفيين، ويسرد قصص الأماكن كمغارة الدم في قاسيون، والجندي المجهول، الذي كان بالأمس معلوماً، فغدا مجهولاً اليوم، ومقام النبي يحيى أو الحسين، وسذاب الجوامع، وحمام المآذن، ونمنمات أيقونات الكنائس.
باب العابرين:
وإذا عدنا إلى الشطر الأول من العنوان اللافت، وهو الشآم باب العابرين، فعنده سأقف، وأستذكر كيف كانت بوابة لهؤلاء الذين تمخض عبورهم عن مقولة:
" من عرف دمشق، فقد عرف الشرق كله."[4] ففي القرن الثامن عشر مر بها الرحالة الفرنسي " الكونت دي فولناي" فكتب عنها ما جعل نابليون يندفع إليها غازياً.
كما زارها الشاعر " لامارتين" عام 1833 ليقف أمامها مسحوراً، قال:" تخترق المدينة أنهر سبعة، وجداول لا يحصيها عدد، يمتد على مدى النظر بين البساتين، والرياض المملوء بالزهور، لترسل أذرعها هنا وهناك..."[5]
إنّ دمشق، مدينة خطتها يد العناية على الأرض، وعاصمة خلقها القدر.."[6]
أما العابر الآخر فهو " الكاتب" دي فوكوي" مرّ بها عام 1875، وحين وقف على جبل قاسيون، راح يلملم السحر، ليضعه في روحه المندهشة فقال:" بقعة كبيرة من الحليب في فضاء أخضر فسيح، تحوطها أشجار المشمش والحور..."
أما العابرون بخيالهم، فهم كثر، فالشاعرة الفرنسية الأميرة " آنا دي نوايا " التي سمعت وقرأت عن دمشق، وعن روحانياتها، فقالت:" هل كتب عليّ ألا أشهد أبداً دمشق الخالدة؟ ولكن حين أغمض عيني، تنساب صورة دمشق إلى أعماق نفسي."
كثر هم العابرون، الذين فتحت لهم الشآم باباً.
فهل أنت عابد كإسماعيل مروة، أم عابر؟
إن كنت الأول فانسج ثوبك من بتلات ياسمينها، ودرْ بعشقك في حواريها، ودعنا نلاحق أطرافه الدائر.
وإن كنت الثاني، فاكتم شهقتك، وأرثها عبر حبرك.